في هذه المقالة لا أطلب من أحد أن يُصدر أيّ حكم. فلا حاجة لشخوص هذه الحكاية أو لي شخصيًا بأية أحكام أو تقييمات. هناك نداء من قاع نمط حياتنا اليومي قد بلغ مسمعي في لحظة تساؤل روتينية عن كل شيء وعن اللاشيء. استطعت بحظّي وبشبكة علاقاتي وبالصدفة أن أتلقّى الشهادات أدناه. ولستُ مسؤولًا عن أيّة تأويلات تخصّ أيًّا من القراء. هذه قصص لا تُروى كلّ يوم، لكنها في كل مكان. انتقيت حكايتين عن نساء الأربعين في ممرّ زمني لا بأس به، دام سنوات من التعرف على كلّ من هبّ ودبّ في هذا العالم.
فيض كينونة أعياها سجن الجسد
التقيتها وقد كانت في فترة هذيان مع نفسها. في كل حركة صغيرة من حركاتها كانت تقول عن نفسها أنها "زانية". باحت لي بعد عناء طويل من التحايل والأسئلة البعيدة والقريبة والدعوات المرهقة لتناول القهوة أنها لم تكن تشعر بأي نوع من أنواع الذنب أو تأنيب الضمير عند تذكّرها لما فعلت، أو عند وصفها لنفسها في صمت بأنها "زانية". بل أتذكر في مرة أنها أبعدت عني صحيفة كنت أطالع صفحتها الأولى وهي تقول "كِي (عندما) نِكتو (من فعل ناك) تحرّرت!". في تلك اللحظة عاد بي شريط الأحداث إلى بداية كل شيء معها، حادثة التعارف والغداء والوداع الأصفر في اليوم الأول وأمل اللقاء ثانية فاللقاء الثاني فعلاقة الصداقة المختلطة باستفادة جنسية.
محدثتي امرأة عمرها أربعون عامًا، جميلة، بمعاييري على الأقل. طولها متر وأربعة وسبعون سنتيمترًا ووزنها سبعون كيلوغرامًا. شعرها أسود وناعم جدًا، بيضاء البشرة وتمارس الرياضة. تثير إعجاب كلّ الرجال وحسد عدد لا بأس به من النساء، ليس لجمالها وذكائها فقط بل لأن لباسها دائمًا أنيق ومن الماركات الأصلية، فزوجها غنيّ وهي أيضًا من عائلة ميسورة وتملك صيدلية. هي أمّ لطفلين.
قد يبدو ظاهريًا أن صديقتنا تعيش حياة مثالية، خاصّة وأن زوجها متفتح ويحب عمله كمستثمر في مجال الصناعات الفلاحية. ولداها يدرسان في مدرسة خاصة أجنبية. لديها معينة منزلية مصابة بالوسواس القهري ولا تترك ركنًا من البيت إلا وعقّمته كل يوم، بل يصل بها الأمر إلى منع الأولاد أيام العطلة من دخول المنزل بعد اللعب في الحديقة إلا بعد غسل الأحذية جيدًا بمرش الماء ذي الدفق القوي.
يبدو كلّ شيء جيدًا، إلى أن هممنا يومًا بالمغادرة من قاعة الرياضة لتقف فجأة أمام بهو الخروج وتتذكر أنها نسيت علبة دوائها في حجرة الملابس. تعود مسرعة. دعوتها إلى عصير طازج وسألتها عن الدواء.
"لا ينيكني منذ أربع سنوات. بعد أن أنجبت الإبن الثاني قررت أن أتخلص مما تبقى عندي من بويضات في رحمي، لا رغبة لي في الإنجاب. اتفقت معه على أن أقوم بذلك. كنت أتخيل أن هذا سيريحنا من أقراص منع الحمل والواقي الذكري وتوقعت أن يسعد بذلك كي نمارس الجنس في بحبوحة التماس المباشر بيني وبينه، أنا أحب هذا، إلا أن خللًا أصاب أداءه ولا أعرف لماذا. أتذكر في ليلة أنني صرخت في وجهه "ألم أعد أعجبك؟ ألم أعد أغريك؟ سأنام في غرفة الأولاد".
"كنت أتساءل إن كان هذا اليأس يصيب نساء الأربعين أم أن اليأس الحقيقي قد أصاب زوجي"
بقيت صامتًا أنظر إلى عينيها. تابعت شهادتها لي وكنت أسمعها بتضامن معها. قالت: "وصلت في لحظة إلى تصديق أنني بلغت سن اليأس وانتهى الموضوع. وكنت أتساءل إن كان هذا اليأس يصيب نساء الأربعين أم أن اليأس الحقيقي قد أصاب زوجي" ضحكت وقالت "هو في سن اليأس موش (لست) أنا هاهاهاها.. لا يبلّ لا يعلّ (عاجز عن كل شيء) هاهاهاهاها".
وسط سنوات جفاف فراشها من أي بلل عسليّ محتمل، قرّرت أن تستسلم محدثتي إلى شعور رهيب سرى في أحشائها وهو عدم الاكتراث ونسيان أنّ لها الحق في حياة جنسية متوازنة. لم تعد تفكر في ليلها، فالأمر أشبه بالعودة إلى الزنزانة بعد يوم كثير الأحداث كما تقول. كانت تصف لي أيامها على أنها "كالبغلة"، توقظ أبناءها صباحًا وتصطحبهم إلى المدرسة. تمر على صيدليتها التي تفتحها المساعدة باكرًا. تمضي اليوم معها في العمل ثم تمارس الرياضة. تتسوّق ثم تعود إلى المنزل: عشاء. دروس الأولاد. تلفزيون. نوم. قالت لي: "في إحدى المرات جاء رجل إلى الصيدلية لشراء حقن بلاستيكية، كان وسيمًا. ناولته ما أراد ولكن حدث أن سألني عن أدوية معقدة وكيفية استعمالها. كنت أشعر برغبة شديدة في حدوث شيء يجعلني أواصل اللقاء به. المهم تبادلنا الأرقام على أساس متابعة الأدوية. ذهبت إلى منزله في إحدى المرات ومارست معه الجنس. لم أحس بلذة جسدية بعينها لكن "كي نكتو تحررت!".
ـ من ماذا تحررت؟
ـ من أن قدرًا قد رُسم لي على أنني فقط لزوجي. وعندما لا يوجد هذا الزوج، هل سأكون لشبح؟ لقد تحررت لأني غادرت سجنًا يُسمّى "خدمة (عمل)، دار، صغار، دار، خدمة، صغار، سوق، مدرسة، دار..". استمعت إلى جسمي بعد سنوات من صمته المُوجع. نعم أنا "زانية". لقد عدت للنيك. ما ألذّه في هذا العمر!
ربما لم تجد هذه السيدة تسمية أخرى غير "زانية" كي تستطيع التحكم لغويًا في وصف ما حدث معها، لكني متأكد أن كلمة "زانية" بشحنتها الدينية تُعد أمرًا غير مطروح في منظومة رؤيتها للأشياء، أخلاقيًا على الأقل. ما أعجبني أنّ هناك نكهة نيتشويّة في فصاحتها الوجدانية عندما تصف لي كيف كان رجل الصيدلية يولج قضيبه في مهبلها. قالت: "شعور مختلف، ليس شعور الفراش والجنس والرجل فقط، كنت أحس أن حياة أخرى تبدأ معي... بل، إن حياتي عادت لي". وكانت تفيض شوقًا للعقِ قضيب رجل آخر و"لم لا ابتلاع منيه" مثل أفلام البورنو.. أسرّت لي بذلك مرات عديدة.
هناك علامات تدُلّك مباشرة على أنّك إزاء امرأة في الأربعين. ليست خطوط العينين، وليس شكل الجسم وليست انتفاخات الصدر أو تلك الشحوم المشتهاة في جوانب البطن أو في الأرداف. هنالك رسالة تعلو يد كل امرأة في الأربعين وتدلّ عليها. تجاعيد خفيفة ومغرية، تختلط بعروق خضراء وزرقاء تخرج كالهضاب من جلدها. هي كالرسوم الملوّنة تصوّر غسيل الأواني، ومسك مقود السيارة، والطهي، ومسك أبنائها عند قطع الطريق ومحفظة النقود والوسادة وفناجين القهوة للضيوف، وتفاصيل أخرى. هناك أيضًا ـ وقبل كلّ شيء ـ آثار ضرر واضح للسلطة تبوح بها نظرتها الخاطفة بأنينٍ خفي كلّما أتيتَها على حين غرة وهي تبحث عن مفتاح منزلها بين أكوام أشيائها الحميمة داخل حقيبتها.
أغلب نساء الأربعين اللواتي التقيتهنّ يحفظن لعبد الحليم حافظ، إذ تتلاءم طفولتهن وجزء من مراهقتهن مع ذوق شديد التعلق بذلك الفتى. حتى وإن راوغت إحداهن بالعندليب فستواجه ذوقًا أبويًا في عشق أم كلثوم.
شكرًا لإضراب مطارات إيطاليا
شهادة أخرى من امرأة أربعينية تعارفنا خارج تونس. كان عمرها واحدًا وأربعين عامًا وجسدها ثرثارًا وناعمًا يبوح بقدرات خارقة في الفراش. كنا قد تشاركنا في رحلة عودة من ميلانو إلى تونس. حدث أن تأخيرًا طويلا في الرحلة بسبب إضراب أعوان أبراج المراقبة بمطارات إيطاليا قد أرغمنا على البقاء لساعات في انتظار فتح المجال الجوي.
ذهبنا إلى مطعم وسط ميلانو، اسمه "مطعم الأغراب". كان قرب محطة القطار. سألتني إن كنت مرتبطًا فأجبتها بمرح: "لا". تناولنا الغداء والبيرة، وقالت لي: "زوجي يعيش هنا في إيطاليا وأنا في تونس. آتي تقريبًا ثلاث مرّات في السنة". انساب حديثنا طويلا عن الزواج وتقاليده وعاداته والهدف منه. وصلنا إلى نقطة هامة في الحوار وهي الجنس. نظرت بخجل جريء وقالت: "مللت زوجي". سألتها إن كان بشكل عام فقالت: "لا، مللته في الجنس". كان عليها أن تسترسل في كلامها كي لا تشعر بتأثير الحرج عليها، وقالت: "أنا متأكدة أنه يخونني ومنذ مدة طويلة. تحملت هذا طويلًا إلا أنني فشلت في أول اختبار".
ـ هل تحدثيني عنه؟
ـ حدث أن تركت الأولاد عند أبيهم هنا في إيطاليا، وعدت إلى تونس لأسباب مهنية عاجلة. كنت أشتاق إلى حياتي الأولى أيام الجامعة عندما كنت أطيل السهر في الويكاند (نهاية الأسبوع) مع الأصدقاء في الرقص والشرب. اتصلت بصديقة قديمة وطلبت منها أن نشارك في احتفال عيد ميلاد صديقة أخرى، وفي الحقيقة كانت تعلّة كي ألهو قليلا.. ولا أخفيك كانت فكرة خفية تجول في خاطري تراودني منذ مدة، وهي أنني سألتقي بشاب وسيم وأقضي معه ليلة حلوة. في تلك الفترة كان قد مضى وقتٌ طويل على آخر مرة مارست فيها الجنس مع زوجي. وبالفعل ودون تفاصيل طويلة، التقيت شابًا ثلاثينيًا في حفل عيد ميلاد صديقتي وكنت قد وضعته أمام حتمية العودة معي إلى المنزل. هناك صوت في داخلي كان يقول أنني أم وعمري تجاوز الأربعين وأن هذا لا يجوز. لكني لا أستطيع إطاعة تلك الأوامر والنواهي، صدري كان يعج برغبة عارمة في أكل هذا الشاب في فراشي الليلة وبقسوة وعنف.
ـ ثم؟
ـ عدنا إلى منزلي. كنت في حالة إثارة ومرح وخوف خفيف ولذة لا يمكن وصفها. كأنني شابة في العشرين. عرّفته على منزلي: هنا المدخل، المطبخ، غرفة الاستحمام، الصالون، غرفة الأولاد، غرفة النوم. سحبني إلى جانب الفراش وقبلني وكان طعم شفتيه خليطًا من التبغ واللعاب والفودكا. خلعت فستاني وألقيته جانبًا، بقيت عارية، خجلت هنيهة من جسدي لكنني مسكت برأسه ووضعته فوق ثدييّ. خلع ملابسه بعنف. كنت أطيعه عندما طلب مني الركوع ولعق قضيبه، كنت أشهق من شدة الإثارة والفرح. "يا إلهي أنا أفعل هذا وأنا سعيدة!". طلب مني أن أجثو على ركبتيّ ويدي في وضعية حيوان يمشي على أربعة. وَلَجني من شرجي وليس من مهبلي. أخرجه ووضع فيه بصاقًا ثم أعاد الإيلاج. كنت أتبع تعليماته شاعرة من جديد أنني مراهقة أعتبر الجنس أمرًا محرمًا ومثيرًا. كان يؤلمني جسديًا لكنني كنت سعيدة. طلبت منه أن ينيكني من مهبلي فكان لي ذلك. أول قضيب غريب يدخل مهبلي منذ تسع سنوات زواج برجل لم يقبّل عنقي ولا مرة. كنت أرى الشاب من فوقي مخرجًا للخلاص، وكنت أحس بهزات جماع متتالية. كنت أستمتع وأصرخ وأقبله بلهفة وأنظر في عينيه، وسمحت له أن يقذف بداخلي.
لطالما شبّهتُ نساء الأربعين بالمشمش الذي نضج بشدة في أعلى الشجرة
في كل مرة أفكر فيها في أمر هاتين المرأتين كنت أشعر بخوف يجول في صدري، خوف من شكل مجتمعنا الذي لا يتلاءم مع نداءات إنسانية صرفة كنت أراها في عيني هاتين السيدتين. لا أعرف تقييم ما صرحّتا به لي، وما زلت غير قادر على التقييم. لكن النقاط المشتركة بينهما كثيرة، لعل أهمها الرغبة والشوق في العودة إلى سنوات العشرين. ربما هروبًا من سن اليأس القادمة خلال عشر سنوات، أو هو اكتئاب واستياء من حياة رتيبة لا يفقه فيها الزوج شيئًا في عشق النساء. قالت لي الصيدلانيّة مرة: "تمنيت لو أن زوجي كان قليل الأدب معي، أحب أن أكون مع رجل خشن وقليل الأدب في الفراش. زوجي لا طعم له، حتى زبّه لا طعم له.. لقد مللته".
لطالما شبّهتُ نساء الأربعين بالمشمش الذي نضج بشدة في أعلى الشجرة، ينفطر إلى شقّين بشكل تلقائي ويقطر عسلًا. كانت أمي تمنعني من لبس قميص نصف كمْ في الربيع، كانت تسمح لي بذلك فقط عند بداية موسم جني المشمش. كنت أرافق أبي إلى الضيعة وكان دائمًا يقول لي "حبات المشمش المُدرّة للعسل هي لعشاء الليلة ولا يجب تركها أو تخزينها لأنها تمعس سريعًا وتفقد بهاءها".
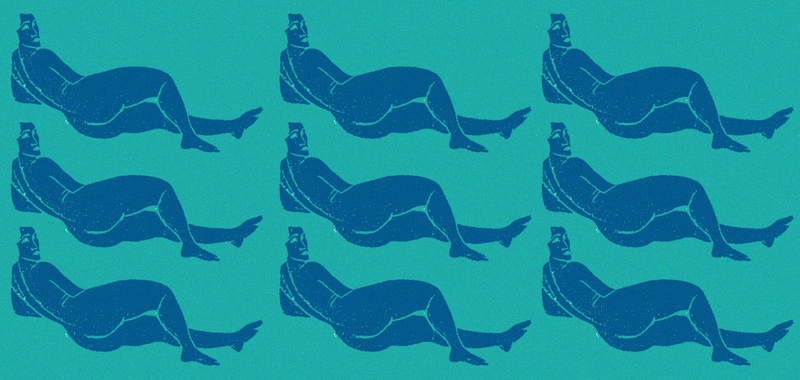
إضافة تعليق جديد